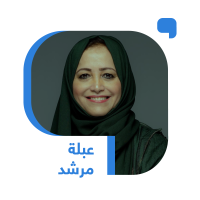وحيث إن التعليم بمؤسساته المختلفة ومستوياته المتباينة يعد الحاضن الأساس والقاعدة الأولى لبناء المعارف والقيم لدى أفراد المجتمع، لكونه المؤسسة الوحيدة التي تحتوي جميع أفراد المجتمع بين جنباتها، فهو المسؤول الرسمي عن غرس جميع القيم التربوية والمعرفية التي يتطلب وجودها بين الأفراد، والتي تعكس رؤية المجتمع وفلسفته، كما تحقق تطلعات الوطن المنظورة، وذلك ليس تهميشا لدور الأسرة وأهميته في البناء التربوي، ولكن نظرا لتفاوت الأُسر في قدراتها وإمكاناتها ومستوياتها المعرفية، في القدرة على زرع تلك القيم، فإن التعليم يبقى هو المؤسسة الوحيدة القادرة على تحقيق مستهدفات المجتمع وفلسفته التربوية والمعرفية.
وبملاحظة نظم التعليم المختلفة وسياساته، خاصة في الدول المتقدمة، نستطيع أن نستشِفّ ونتلمس نوع الرؤية التي يتبناها تعليمهم، كما نستطيع مشاهدة وفهم الرسالة التي يسعون إلى تحقيقها، من خلال ما ينفذونه من برامج وأنشطة وما تتضمنه مناهجهم الدراسية ومقرراتهم، والتي يخدم جميعها أهدافهم وتطلعاتهم التربوية والمعرفية، وبما يتواءم مع مبادئهم وقيمهم الاجتماعية، وتطلعاتهم الوطنية.
وعند المقارنة بين تعليمنا وتعليمهم، نقف حائرين في ذلك الغموض وعدم الوضوح في الرؤية الذي يكتنف ما يستهدفه تعليمنا، سواء في ممارساته التربوية، أو في التطبيق الفعلي لرؤية مؤسسية تعكس طبيعة نظامه، أو تترجم خطط وأنظمة تضمنتها لوائحه، وذلك يدفعنا إلى التساؤل عن ما هي فلسفة التعليم عندنا؟! وما الأهداف التي بُني على أساسها ذلك النظام التعليمي والمناهج؟!، بالطبع لا نبحث عن الإجابة خلال المكتوب من اللوائح، أو المسطر بين الملفات من رؤية ورسالة وأهداف وأنظمة ومبادئ، وإنما نبحث عنها في مخرجات ذلك التعليم وفي ممارساته اليومية المختلفة، التي تفاجئنا ما بين اليوم والآخر بقرارات ارتجالية أو حلول ضعيفة ومؤقتة لمشكلات أزلية، تحتاج إلى دراسات علمية متخصصة، يمكنها أن تسهم في الحد من التعثر الذي يواجهه تعليمنا، ويعزز من جهودنا التنموية المبذولة.
يتغير المسؤولون وتتبدل القيادات، ونجد أنفسنا ما زلنا نحوم حول ذات المشكلات ونفس التحديات المتصلة بالتعليم بكافة منظومته، سواء ما يتصل بالموارد البشرية، من مستوى تأهيل وتدريب وتوظيف وأجور ونقل وإدارة ومخرجات، أو ما يتعلق بالبيئة التعليمية من مبانٍ ومتطلبات تعليمية وترفيهية وصحية وغيره، أو الموارد المالية وما يرتبط بها من نفقات ورواتب وعلاوات، أو المناهج والمقررات الدراسية وما يتصل بها من محتوى وأنشطة، أو هيكل مؤسسي وما يتصل به من أنظمة وسياسات ولوائح؟ لا ننكر أنها إرث متراكم من الإشكالات، وأن معالجة بعضه تحتاج لفترة من الزمن لنلمس نجاحه، ولكن التساؤل المطروح متى ينتهي ذلك كله، لنبدأ صفحة جديدة من التعليم الصحيح المأمول؟ متى يمكننا تحقيق الجودة في التعليم؟ كيف نستطيع أن نرتقي بتعليمنا؟ كيف يمكننا أن نترجم مخططاتنا ورؤيتنا إلى واقع نعيشه؟ لماذا تنجح الدول المتقدمة في معالجة تحدياتها ونتعثر نحن؟! لماذا يستمر حل الإشكالات ذاتها لدينا لسنوات مستمرة ولا تنتهي؟! لماذا نحوم حول الدائرة نفسها ولا نستطيع الخروج منها بجديد فاعل ومهم؟!
يعلمنا أسلوب البحث العلمي أن حل المشكلة يتطلب تحديدها بدقة علمية، حتى يمكننا أن نفترض الحلول الملائمة لحلها وفق معايير علمية، تستند لدراسات تجريبية أو نظرية تناسب المشكلة المدروسة، ومن خلال تحديد أهداف واضحة لدراسة المشكلة يتمكن الباحث من رصد كافة المتغيرات المتعلقة بالمشكلة، للوقوف على مدى تأثيرها وعلاقتها بالمشكلة، وبذلك يتمكن الباحث من الوصول إلى نتائج علمية مهمة، تفسر أسباب المشكلة المدروسة، وتقترح توصيات مناسبة لمعالجتها وحلها أو الحد منها.
ومن المؤكد أن تعليمنا يواجه عددا من التحديات والإشكالات المزمنة التي شملت كافة منظومته ولم توجد لها حلول جذرية حتى الآن، فتستمر تلك التحديات لسنوات وتتجدد لتتراكم إشكالاتها، والسبب أننا لا نواجه حل مشكلاتنا بأسلوب علمي يتصدى له المتخصصون في المجال المعني بالمشكلة، وهم كُثر، وإنما تُتخذ السياسات والإجراءات بصورة وقتية وعشوائية، بعيدا عن أي منهج علمي مدروس، وتهميشا لكل ما ينادي به العلم من أساليب علمية لحل المشكلات في مواجهة التحديات، وعليه نظل ندور ونحوم حول ذات المشكلات، لتتراكم فيتسع شقها ويتعقد رتقها، علاوة على ما يستجد من إشكالات جديدة نتيجة للإخفاقات المعلّقة التي تبحث عمن ينتشلها من وحل غرقت فيه.
مما لا شك فيه أن الدولة أنفقت كثيرا على التعليم بجميع مستوياته، سواء التعليم الداخلي أو الخارجي، والتعليم العام والتعليم العالي، وقد أثمر ذلك -بفضل من الله- عن مخرجات متميزة، يفخر بها الوطن في جميع التخصصات العلمية التي يحتاجها الوطن في كافة مجالاته ومؤسساته وبرامجه التنموية، والتساؤل الذي يفرض نفسه، أين هؤلاء من المشكلات والتحديات التي تواجه تعليمنا في كافة منظومته الإدارية والتعليمية؟! لماذا لا يُستعان بتلك النخب المتخصصة في معالجة وحل المشكلات التي يواجهها تعليمنا؟! لماذا نُهمش المتخصصين في العلوم المختلفة في التربية والتعليم، ونلجأ إلى الأقل حنكة والأضعف علما؟! أين الأكاديميون المتخصصون في المناهج؟! أين المتخصصون في طرق التدريس والتخطيط التربوي؟! أين الأكاديميون المتخصصون في العلوم المعرفية المختلفة؟! أين وأين؟ لماذا لا يستفاد من جميع هؤلاء؟! هذا هو الفرق الجوهري بين تعليمنا وتعليمهم، هم يستفيدون من مخرجاتهم العلمية المتخصصة في معالجة تحدياتهم وتطوير برامجهم بأسلوب علمي صحيح، بينما نهمش نحن مخرجاتنا المتميزة، ونلجأ لإجراءات وسياسات تتغير ما بين اليوم والثاني لأنها عشوائية، ولم تُبنَ على أسلوب علمي صحيح في دراسة المشكلة وتحديد متغيراتها، فنتعثر في معالجتها وحلها.