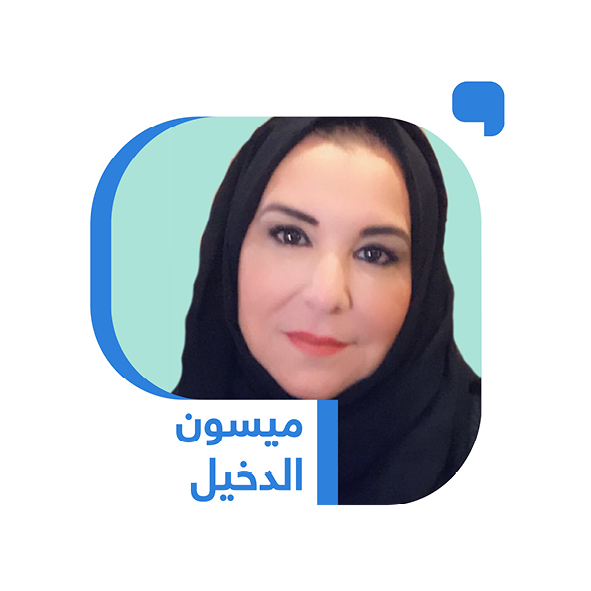الأمر المهم الذي يفوتنا هنا، هو أنه عندما نصنف الآخرين فإننا لا نتعرف عليهم، أو لا نعرف مَن هم، ولا حتى نفهم من أين أتت أفكارهم أو معلوماتهم، ولكن الأكثر أهمية هنا، هو أن التصنيفات تحرمنا من معرفة ذاتنا وفهم ماهية معلوماتنا ومن أين أتينا بها. لقد ذكر بعض الحكماء أن الحديد يشحذ الحديد، والفكر يشحذ الفكر، ولهذا فقط حينما نشارك الآخرين ممن يفكرون بطريقة مختلفة عنا يمكننا أن نشحذ مهارات التفكير لدينا، أن نصبح قادرين على رؤية وجهة نظرنا من خلال عرضها من وجهة نظر الآخر، أن نصبح قادرين على تنقية وشحذ جوهر معتقداتنا وأفكارنا.
من أين حصلت على معتقداتي وآرائي وأفكاري؟ من أين أتت أخلاقياتي وقيمي؟ هل اخترتها، أم اختارتني؟ ألا يجب أن نطرح على أنفسنا مثل هذه الأسئلة؟ قد يبدو الأمر غريبا أو حتى مخيفا. كيف نعرف حقًّا وبكل تأكيد ما نحمله داخل أنفسنا من فكر ومعتقد؟ ربما لأننا نختبئ وراء التصنيفات، فلا نضطر إلى مشاركة غيرنا بما يجول في داخلنا، فلا نعرف من هم، ولا نعرف من نحن، ولسوف يستمر الأمر كما هو إن لم نتخذ قرارا بإعادة صياغة طرق تواصلنا وحواراتنا مع الآخر.
كثيرا ما راودتني مثل هذه الأفكار، وهذا البحث المستمر عما يجري في داخلي، وإن كان ما أحمله حقيقة أو مجرد انعكاس لما تمّ ضخه في داخلي من قبل الأهل والمجتمع والأقران، وحتى الإعلام ووسائل الترفيه، لم يكن ذلك قريب العهد، بل هو منذ أن كنت طالبة أدب إنجليزي في المرحلة الجامعية، كنت أسأل نفسي: «ماذا بعد؟»، نعم كنت أعشق الأدب، حيث كنت أبحر معه لأتعرف على الثقافات وطرق التفكير وطرق الحوار والمواجهة والهروب، الانتصار والفشل، الحب والكراهية، التعاطف والخذلان، الذكاء والغباء، البخل والعطاء، الخوف والجرأة.. وكانت تثيرني فكرة أن كلمات قد تحرّك فكرا وتحيي مشاعر، لكن من الأوراق انتقلت إلى الحياة، ومن الحياة تعلمت أكثر. أكثر الدروس تأثيرا أتت من غرباء على مقعد سفر، أو في محطة انتظار، لا توجد بيئة أكثر أمانا في العالم للكشف عن الذات من مقعد تشغله بطريق الصّدفة شخصية مجهولة بجانبك، شخصية لا تتوقع لقاءها مرة أخرى في حياتك. كم مرة شُغل ذلك المقعد بشخصية حدثتني عن قصص لم تكن لتشارك بها مع أقرب الناس إليها، لم أكن أرد أو أحكم أو حتى أقاطع، كنت أشعر في تلك اللحظات بأنها لم تكن تتوقع مني شيئا سوى الإصغاء وهي تتحدث، والحقيقة هي لم تكن تتحدث إليّ، بل كانت تتحدث إلى ذاتها، ولكن كنت انعكاسا حيّاً لذاتها، فتتحدث بكل أريحية إليها، ولأنني لم أشغل عقلي بالرد أو التعقيب، فقد أصغيت باهتمام وتركيز كبيرين، تعرفت إليها بشكل أفضل، وخلال ذلك تعرفت إلى ذاتي أيضا، وكما يقول بعض الأدباء «الطريق يؤدي إلى الطريق»، وجدت نفسي في مرحلة أخرى من حياتي في مكان أخذتني الصدفة إليه، وجدت نفسي في قاعة مع أستاذة من أصول عربية في جامعة أجنبية، منذ أن رأيتها وعرفت اسمها تحرك عامل التصنيف في داخلي: «نعم هي من أولئك»!، وكنت قد وعدت زميلتي بأنني سوف أترك القاعة عند أول بادرة من الشعور بالملل. ثم بدأت بالحديث، كانت واضحة وبليغة، وكانت واسعة المعرفة، كل ذلك وعقلي يفكر، كيف لصاحبتنا أن تمتلك نفس قدرات أساتذة الجامعة الأجانب؟! كان عليّ أن أختار: هل سأرفض كل ما كانت تعرضه علينا فقط لأنني لا أتقبل فكرة أنها متمكنة بناء على أصولها، أم أصغي إليها لأستزيد مما لديها من علم ومعرفة؟! وعدت كطالبة في قسمها، وأخذت أمطرها بالأسئلة وأحاورها وأجادلها، ولكنها فنّدت كل حججي، وأجابت عن كل تساؤلاتي، أنا التي كنت أعتقد بأنني قد قرأت ما يكفي أن يجعلني مثقفة على أعلى المستويات، وقفت أمامها كمبتدئة أصغي، فأتعرف ليس عليها فقط، بل على ذاتي أيضا، وهنا بدأ النمو الحقيقي للمعرفة في داخلي. لقد انهار ذلك الحائط الذي كان يحجب عني عالمَيْ العلم والمعرفة الحقيقيين، وبدأت أتذوّق رحيق الفكر، ومع حكمة الإدراك المتأخر تنبهت إلى أنني كنت أُجهّز لمثل هذه اللحظة منذ وقت طويل، ليس فقط بالتمكن من مهارات الإصغاء، ولكن ربما منذ أن كنت في المدرسة، عندما حدث أن حاورتني مديرتي بعد أن تمردت على كل شيء، ورفضت حتى الانصياع لتعليماتها التي عُرِفت بها، كم كانت صارمة وحازمة في جعلنا ننفذ ونطبق، سألتني حينها: «كيف ترين نفسك في المستقبل؟»، أجبتها بتحدٍّ: «متمردة»!، نظرت إليّ، وقالت: لماذا؟ ماذا تقصدين؟ لماذا؟! كيف تصنفين نفسك بمفهوم لا تعرفين ماهيته؟ أجبتها: بل أعرفه، فأنا لا أريد كذا، وأكره كذا، وأتضايق من كذا، وأصغت بكل اهتمام إلى القائمة، ثم أجابت بهدوء: «أنت تتحدثين عن رفض أمور غالبيتها لا تعرفين أي شيء عن خلفياتها»، هنا حصل شيء غريب، اعترفت بأنها على حق، فعلا غالبية ما ذكرت لا أعرف كثيرا عن خلفياته، وعلى الفور غيرت تصنيفي لذاتي من متمردة إلى رافضة، وهذا الوصف لذاتي بقي معي لسنوات طويلة حتى التقيت أستاذتي، فأنا لم أكن أعتقد مطلقا أنه يمكن أن يكون لديها ما تعلمني إياه إضافة إلى ما كان عندي، وللمرة الثانية في حياتي أقتنع بإعادة النظر في تصنيفي لذاتي، فتحولت من رافضة إلى عاشقة للعلم والمعرفة، ربما لا أتفق مع كثير ممن أحاورهم اليوم في كثير من الأمور، ولكن على الأقل أدرك وأكتشف من خلال الحوار لماذا وكيف وعلى ماذا بنيت تلك الآراء والمعتقدات لديّ، وقبل ذلك أجتهد لكي أفهم لماذا وكيف وعلى ماذا بنى الآخر آراءه ومعتقداته. الانفتاح الفكري لا يعني تقبّل كل ما يقدّم إليك على أنه صحيح أو أنه الحقيقة، الانفتاح يعني تقبّل احتمال أن تكون الحقيقة عند مَن لا تتوقّع منه ذلك، مثلا عند مَن يختلف معك، وتكتشف وأنت تحاوره أنه على صواب، أو تتأكد أكثر من أن ما لديك هو الصواب، ولكن إياك أن تتوقف عن البحث والحوار والإصغاء حتى لا تتجمد معلوماتك وتتحول آراؤك إلى معتقد، بل وتصبح غير قادر على إقناع حتى ذاتك: لماذا أنت تؤمن بها!. وهنا لنعد إلى الأسئلة في بداية المقالة: من أين حصلت على معتقداتك وآرائك وأفكارك؟ من أين أتت أخلاقياتك وقيمك؟ هل اخترتها أنت؟ أم هي التي اختارتك؟