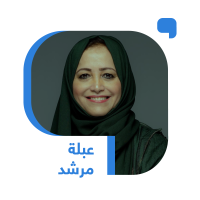وتزداد قوة التأثير عندما تكون القوة سلبية وخطيرة، بما يتولد عنه ردة فعل طبيعية مقاومة للحد من الضرر والنجاة، وتلك سنة الله في الكون، لحفظ الإنسان على وجه الأرض لأجل معلوم عنده تعالى.
تعيش دول العالم بكل شرائح مجتمعاتها ومؤسساتها تأثير جائحة كورونا وتبعاتها السلبية، اجتماعياً واقتصادياً، ذلك الوباء الذي طغى على جميع ممتلكاتنا ومواردنا البشرية والمادية، فُسخِّرت لمقاومته الميزانيات، ووُجّهت نحوه السياسات، واتُّخِذت من أجله الإجراءات المختلفة للحد منه، والذي أدى إلى استنزاف كثير من الجهود والنفقات والإمكانات التي تفوق التوقعات المحسوبة، ولأن الإنسان كان هو الثمن، فاستحق هذا البذل السخي والرعاية الدولية والوطنية.
وإذ إن التأثير شامل والضرر عام، وليست فيه استثناءات منتقاة، أو تمييز مختار لأحد دون غيره، فكان الخير سخيّا والعطاء كريما بحجم الوطن، وبحجم المسؤولية التي يستشعرها المؤمن في تعاطفه وتفاعله مع أخيه المؤمن، مصداقاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» رواه مسلم.
هناك من النائبات التي تأتي فرادى، فيكون تأثيرها محدودا في جماعة أو منطقة أو دولة دون غيرها، ومنها ما يكون ضرره عاما، وتأثيره شاملا، فبالتالي يشترك الجميع في مقاومته، للحد من أضراره وتبعاته المختلفة، وإذ إن جميع دول العالم تضررت من وباء كورونا بدرجات مختلفة، فإنه لا مجال إلا للتعاون وتبادل المصالح على مختلف المستويات، لإنقاذ مركب الحياة المشترك للبشرية جميعها، للخروج من كارثة تفشت بين شعوبها، استهلكت مقدراتها لتضرب مكتسباتها المختلفة.
ولأن الشعوب تسير مع أوطانها في مركب واحد، تزدهر وتنتعش حيث يجود العطاء، وتكافح وتصبر وتتعاون في النائبات، فإن التكاتف والصمود هو السلاح الذي نواجه به الأزمات والمحن مجتمعين، إذ إن كثيرا من صعوبات الحياة وتعقيداتها يمكن تذليل تحدياتها بتغيير شيء من سلوكياتنا المعتادة، وتحديث آلية تعاملنا معها بأسلوب يختلف عن سابقه، وبما يتناسب مع طبيعة الحدث، وما طرأ من تغيرات دولية ووطنية، وبما يترجم ما تختزنه عقولنا ومداركنا من تجارب الحياة وعلومها التي اكتسبناها، لتكون أفعالا وتصرفات تسهم في تجاوُزِنا مختلف التحديات التي نواجهها.
لعبت الظروف الاقتصادية والتنموية التي تميزت بها المملكة، كدولة ريعية يعتمد اقتصادها على البترول، دورا أساسيا في بناء كثير من أنماط الحياة التي نعيشها اليوم، إذ كانت الوفرة والرخاء في مجتمع اختزل مراحل التنمية المتدرجة، سبيلا إلى الاستهلاك الفائض عن الحاجة في مختلف متطلباتنا، وقد آن الآوان لنعمل على ترشيد استهلاكنا، وتصويب معاملاتنا لكثير من أوجه ومجالات استخدامنا لوسائل الحياة اليومية ومستلزماتها، والتي أصبحت فيها الكماليات تنافس الأساسيات، وبما يمكننا تقنين نفقاتنا بما يتناسب مع ظروفنا الاقتصادية ومستوى الدخل الذي نعيشه.
بالتعاون والتكاتف بين فئات المجتمع المختلفة، تتذلل العقبات وتتمهد السبل في احتواء التغيير، ليكون منهج حياة يستوعب المتغيرات الطارئة، عندما يستشعر رجال الأعمال والتجار من أصحاب المؤسسات المختلفة والخدمات العامة، أن المسؤولية وطنية، وأن الجميع أسرته وإخوانه وأبناؤه، ويعملون على الحد من الغلو في الأسعار والتقليل من نسبة الأرباح المضاعفة، فإن ذلك سيسهم -بلا شك- في التخفيف من تأثير الإجراءات الوطنية التي فرضتها الظروف الاقتصادية والاحترازات المطلوبة، فالمواطنون آمنون وسالمون طالما هم في عهدة الوطن، وتحت سمائه وبين عشيرتهم.