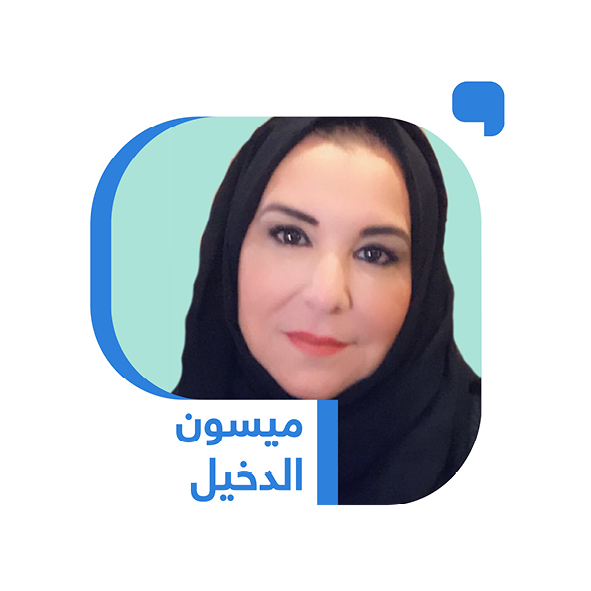هروب، نعم إنه كذلك! ما وجِدَت الذاكرة إلا لكي نعود إليها، ونحتمي داخل أثوابها كطفل يحتمي بأحضان أمه، حيث يغمض عينيه وهو يعلم أن كل شيء سيكون على ما يرام. بالأمس كانت لي أحلام وأمانٍ، نعم وبعض آلام من الحرمان والفقد، ولكن طعم الحياة كان حلوا كطعم شطيرة السمن والسكر التي كانت تحضرها لي جدتي في المساء، رغم أنها كانت تفضل أن أختار نوعا آخر حتى لا أضر بصحتي، لكنها كانت دوما ترضخ لرغباتي، وهكذا كنت أرى أيامي حبلى بالأحلام والخطط التي كنت أراها تتجسد أمامي وأنا أحلق بروحي عاليا وبعيدا عن الأرض، بينما كانت تشدني إلى الواقع وتقطع كلما استطاعت سلوتي لأعود إليها، فأحرك أحرفي لأسطّر على الورق عبارات أجمعها بين أصابعي وأحركها لتمر كعصاة ساحر، فتنتفض الأحرف وتتحول إلى بساط أتربع عليه وأطير ثانية إلى المستقبل، لم أكن أتوقف لأفكر بماهية الحياة، كل ما كان يشغلني أن أكون بطلة قصصي، وأن أراها تتجسد أمامي وأنا في قلبها، كالقمر في جوف الليل الدامس، وعلى ضوء خيوطه الفضية أتزحلق وأخترق الغيم.. أعمق وأعمق إلى أن أسمع اللحن الذي يتردد داخل روحي يعلو ويعلو إلى أن يحتضنني، عندها أبتسم، أغمض عينيّ وأشرب من نهر النغم حتى أنتشي.. كم تحايلت على الوقت، كم تحدّيت، وكم ركضت بسرعة لأسبقه! إمّا أن أصل إلى شيء، وإما ألّا أصل إلى شيء، كم أشعلت نيرانا وكم أطفأت.. وكم رفضت عيناي أن ترى الفراغ والانكسار اللذين تراكما داخلي. كم ثرت على لا شيء وعلى كل شيء! كنت التناقض والتكامل، كنت الفراغ وكنت الانشغال، كنت المُخرِج على مسرح يعج بالممثلين ممن كانوا يدخلون من باب ويخرجون من آخر حتى لم يعد يدخل أحد، وينتهي بي الأمر وحيدة على الخشبة أحدّث نفسي بمنولوج أجاري به «هامليت»، فقد كنت أكره ضعف «أوفيليا».. ويدق جرس من بعيد منذرا بانتهاء المسرحية.. أنحني أمام جمهور غائب، وأعود إلى مسرح آخر بممثلين آخرين، أعود إلى الواقع في انتظار أحداث قادمة من حياتي! هل هذا هروب؟ نعم! ولكنه هروب مَن يستطيع أن يعود إليه.
أعلم أن هنالك كثيرا منا من يفضل ألا يهرب إلى الذاكرة، فقد تحمل إليه بين طياتها ما هو مؤلم، وقد يكون حاضره يخنقه فلا يستطيع حتى أن يغمض عينيه ليعود إلى الأمس، ربما نسي كيف! أعلم أنني لا أفهم تجاربكم، ولكن لمن يعرفني: أنا هنا للاستماع، بل للإصغاء، فمَن يريد أن يُخرج ما بداخله فليبحث عن أصحاب الأيدي الممدودة، فهذه رسالتهم وهم كثر! انظر في الأخبار مرة أخرى، على زخمها ستجد قصصا بشعاع الشمس ترسل خيوطا ذهبية لتضيء حياتنا، قد تتخللها سحابة سوداء من الأحداث، لكنها كالشجرة المثمرة في انتظار من يمد يده ليقطف ثمار الأمل والراحة، قصصا مثل مَن أنقذ ومن ساعد ومن في قلب الفوضى والخطر وقف شامخا ومد يده ليصب في الأنفس نسمات من الرحمة والحنان، فلانت القلوب وتوقفت الأنفس لتصغي وتشارك، ومن ثم تنقل كل هذه المحبة والسلام إلى الذي بجانبها، وتكبر السلسلة لتلف العالم وهي تلامس الأرواح فتهدأ النفوس وترتاح، لاحظ نفسك وأنت تقرأ أو تشاهد مقطعا من هذه المقاطع كيف تتحول المشاعر في داخلك إلى حلوى القطن تذوب في داخل روحك وتجعل ثغرك يتحرك ويبتسم!
نعم هنالك أناس يريدون الاستماع والفهم والمساعدة بأيديهم أو بكلماتهم، يمرون على الجروح كنسائم باردة في ليلة صيف حارقة، أو كحلاوة طعم المطر على الشفاه بعد العطش، قد لا تتصدر قصصُهم الأخبار، ولكنهم كثر وقصصهم تحدث طوال الوقت، أناس عاديون، ليسوا بمشاهير، لنبحث عنهم ولنحتفي بهم ونستقي منهم مشاعر الطيبة والهدوء والثقة، وإن استطعنا أن نتواصل معهم فلن نجد عندهم سوى العطاء، أليس هذا أفضل من تضخيم خلافاتنا والبحث عمّا يؤججها؟ أليس هذا أفضل من الصمت وترك نيران الوحدة، أو الغضب، أو الألم.. تأكلنا، وتحولنا إما إلى رماد وإما إلى بركان؟